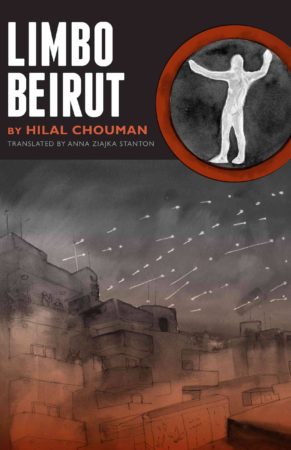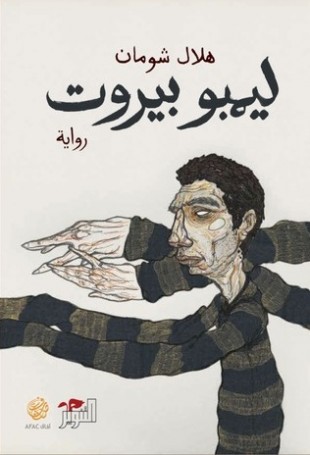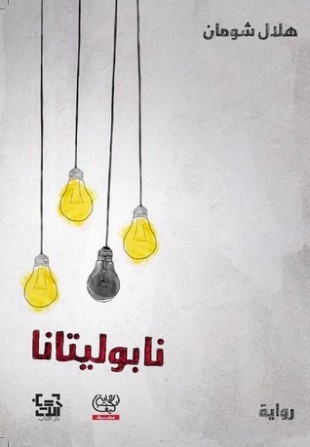قصص قصيرة نُشِرَت في الصُحُف
«home»: لا أحد يُطفئ هذا الجهاز
نُشر في July 29, 2019
لكل قصة بداية، ولو لم تنطلق من بدايتها، ويمكن لقصتنا أن تبدأ على هذا النحو. يجلس ر. أمام اللابتوب مستخدمًا «غوغل مابس». يكبِّر الخريطة على الشاشة ويصغِّرها، يرتفع بها ويهبط فيها، ويتجوَّل في الشوارع. هذه هي المرَّة الأولى التي تتحوَّل المدينة أمام ناظره إلى صورة مسطّحة. يعرف شكل رأس بيروت الناتئ، وخليجه الذي صُرِع فيه التنِّين، لكنَّه لم يدقِّق سابقًا في خريطة المدينة التي ولد فيها. أما الآن، فيكتشف في المدينة تفاصيل غريبة. ينتبه مثلًا أنَّ الناس تُسمي الشوارع بغير أسمائها. هـ. ذكر له الموضوع، وأعلمه أنه سيكتب عنه. لم يأبه ر. وقتها بحديث صديقه، وواصل النظر في المارة الذين كانوا يعبرون الشارع خلفه. كانت لحظة كافية لأن يلمع كل شيء ولأن يبدأ -يبدأ فقط- في فهم أشياء لم تكن [&hellip
..المزيدعالم الكلاب
نُشر في August 1, 2015
يصعب له تخيّل أنّ ما حلم به يحدث أمام ناظريه، فهو لم يعتد أن يرى أحلامه تتحقق. في الحلم، كان يجد نفسه ماشيًا على غير هدى في شارع من شوارع المدينة. الشارع فارغ من الناس، يحوي مباني متلاصقة على جانبيْه، ويغرق بالردم والنفايات، والكلاب تمشي جماعات قربه. كان يخاف من الكلاب، لدرجة أنه كان يسمع دقات قلبه تتعاظم كلما اقتربت منه، لكنّه يبقى يحافظ على مشيه البطيء محاذرًا إظهار خوفه. كان يفكر أنّ الإسراع سيلفت نظر الكلاب، وأنّها ستنقضّ عليه، وأن نجاته مرتبطة بنجاح إشعاره لها أنه متعايش معها. وهكذا كان يكتفي بالمضي قدمًا. لكنّ الكلاب كانت تتجاوزه كأنها لا تراه، ربّما لأنه دخيل على المكان، لأنه هنا وليس هنا، ولأنّ هذا هو عالم الكلاب. وهو عندما كان يتقدم، كان [&hellip
..المزيدعلامات لزمن مقبل
نُشر في July 2, 2015
“كتب لسهى: “أمّا حينما أناقض نفسي بين حديث وآخر فهذا لا يعني أنّني لا أؤمن بأقوالي، تمامًا كما وأنّه لا يشير إلى كوني ألعب أو أحتال أو أكذب، لكن هذه هي طبيعة الكلام نفسه -أيّ كلام. خصوصًا إذا حاول المرء أن يكون صادقًا دائمًا، إذ عليه حينئذ أن يسمح للتناقض الذي يملأ حياته بالدخول إلى قلب كلامه، وإلا فماذا تكون فائدة الكلام؟” – شاي أسود / ربيع جابر – 1 – رفع هيثم كأسه في تلك الليلة من العام 2011، وذكر فارقًا رآه أساسيًا بين الرواية والقصة القصيرة. أحاول أن أستعيد نظريته بتفاصيلها، لكنّ ذاكرتي لا تسعفني تمامًا. فأنا وقتها كنتُ قد شربتُ كأسين على معدة خاوية. لكن ما أذكره -وأرجو أن أكون صائبًا في استرجاع نظريته بلا تشويه- يمكن [&hellip
..المزيدهذه قصّة لتُكتَب
نُشر في September 6, 2014
تفكّر أنه يبنغي عليك أن تغضب في الزحمة، وأن تعبّر عن شعورك بأن تخبط المقود مثلًا، أو تُنزِل زجاج نافذتك لتشتم مَن عَبَر أمامك كأنه يمتلك الطريق. لكنك لا تفعل هذا، ولا ذاك. تكتفي بأن توقف السيارة، وتترك الدراجات النارية الصغيرة تتقافز حولك يمينًا ويسارًا، مسرعةً كأنها اكتشفت أنها موجودة للتوّ، أو كأنها تثبت للمرة الألف انتصارًا متميزًا وسط كوم السيارات المتشابهة المتراصة. ثمّ تنهمك بالتفتيش عن تفاصيل نافرة وسط كل هذه الفوضى التي لم تغب عنها سوى شهور كثيرة. يبدأ الأمر بالأصوات. ما بال أذُنيك قد صارتا أكثر حساسية لها؟ كأنّك تنضمّ لجماعة الآن، أو كأنك تنسحب منها؟ لا تذكر ما يقوله كتاب هيثم الورداني الرقيق “كيف تختفي”. لستَ متأكّدًا إن وَرَد تعاظم الانتباه في فصل الانضمام للجماعة أو [&hellip
..المزيدوقت مستقطع من “السيستم”
نُشر في October 31, 2012
شمع العسل تعمل ليلاً في شركة يعمل موظفوها فيها نهاراً. الضوء ملقىً فقط فوق مكعبك، وكل ما حولك مظلم. ناطحات دبي في الخارج تتوهج بالشبابيك المضاءة كخلايا سداسية في قطع من شمع العسل. ولما تقف لتمشي في الأروقة تضيء لك مجسّات السقف الضوئية الممر أمامك، لمبة إثر أخرى. لا تنتظرها لتضيء، ولا تسرع قبل أن تشعر بك. إيقاعاكما متناغمان. إنه وهم الحداثة محتفياً بك في ليلة أخرى، تستمتع به إلى آخر لمبة تنطفئ وراءك، وأنت تبتعد. وقت مستقطع الكافيتريا. تقف أمام الماكينة. تضغط على «شوكو ميلك». الأضواء في الخارج تصل الزجاج ثم تتكسر. لا تعود متحققة. كأن المكان محظور عليها. شيء ما مرتبك. ليس فقط الضوء مختلف في الخارج عن الداخل. الصوت أيضاً. هل جربت الاستماع إلى صوت البرادات؟ صوت [&hellip
..المزيدحزن ناس الفقاعات
نُشر في October 24, 2012
إنه العام 2112. بعد قرن من الحروب المتفرقة، بُنيَت المدينة البلّورية في بيروت. وُقّع اتفاق بين أطراف الصراع يتضمّن تحييد من لا يودّ المشاركة في الحرب المستمرّة، وإرسالهم إلى المدينة المنشأة، وساعد المجتمَع الدولي بكافة محاوره ماليًّا في إنشائها. جرى ذلك بسهولة غريبة، وتبعه توافق أطراف الصراع على الإشارة إلى المدينة الوليدة كإنجاز حضاري يعيد تلميع صورة البلد في عيون الخارج. قالوا ذلك، وواصلوا مناوشاتهم المسلّحة على حدود التجربة. حُدّد مكان المدينة البلّورية في الوسط القديم. فبعد تدميره المتكرر على مدار المئة عام الماضية، كشف الدمار عن الأبواب السبعة المطمورة التي لطالما قرأ عنها السكّان في كتب التاريخ. كانت رمزية البقعة فائضة بما يكفي ليوافق الجميع عليها مكانًا منتقىً للمدينة الجديدة. ظلّت القنوات التلفزيونية تواكب إنشاء المدينة حتى الافتتاح. تابع [&hellip
..المزيدمقبرة جماعية
نُشر في July 7, 2012
«..وقد خطر لي السفر إلى بلاد الناس». وإذ وصلْت الى هناك، وقفْتُ في الساحة. كان كل شيء ساكناً وفارغاً. عرفت أنّ شيئاً ما ليس على ما يرام. لم تكن الساحة تنذر بأي حركة. حتى إنني كنتُ متأكداً أنّ الوقت متوقف. أخذتُ أفتّش عن ساعة عامة، وصرت أنتقل من ساحة إلى أخرى ومن شارع إلى آخر. لكنّي لم أجد الساعة، وفكرت أن الغياب هذا غريب وغير مفهوم. إذ كيف يمكن أن تسكن المدينة من دون عقرب ساعة ثابت؟ وكيف يمكن أن يتوقف كل شيء من دون موعد مقبل أنتظره؟ وكيف أنتظر تغيّر الثبات من دون أن أكون متيقّناً أن الوقت سيمشي لاحقاً؟ زاد من شكّي هذا أن لون النهار كان غير، حتى إني تحفّظت على وصفه بالنهار. ولم يكن ليلاً أيضاً. [&hellip
..المزيدحفلة إرغام
نُشر في June 13, 2012
1 ـ «ساراوند سيستم» جعلتُ أنظر إلى المشهد من الشرفة. كانت مقدمة السيارة قد تهشّمت بالكامل، وسيارات الإسعاف والشرطة تملأ المكان. تجمّع خلقٌ كثيرون. بعضهم كان يساعد واكتفى آخرون بالتفرج. لكنَّ شيئاً بان غريباً في كل ذلك. لم أستطع تحديده في البداية، ثم ما لبثَتْ الملاحظة أن صعقَتني. كانت الموسيقى تصدح بصوت عالٍ من السيارة المهشّمة. جُرِح من جُرِح ومات من مات فيها، وعاش الراديو صامداً. هذا «ساراوند سيستم» لا يموت، فكّرت وحضن كفّاي كوب القهوة الساخن أكثر. عاجل*: «وضعْتُ دماً على وجهي ليظنوا أني متّ». 2- أغمضَتْ عينيَّ كان عمري أشهراً، ومرّ والداي بسيارتهما بالحاجز الإسرائيلي على طريق صوفر. أوقفهما أحد الجنود الإسرائيليين. لا أذكر بالطبع ما الذي حدث، لكني أحفظ من قصة أمي التي تكررها على مسمعي دائماً [&hellip
..المزيدأثرُ الشيءِ في غَيره
نُشر في June 6, 2012
تعالوا نُشَخْصِن الأمور كثيراً. عندما نظرتُ إلى صورة باسل شحادة، تذكرتُ رواية «رالف رزق الله في المرآة» لربيع حابر. في الحياة، انتحر رالف قبالة الروشة. في الرواية، وعندما يعرف الراوي بالخبر، يتذكر أن رالف مرّ بجانبه مرّة في مدخل مبنى «النهار» من دون أن يتكلّما. ينظر الراوي إلى صوَره، يتحدث إلى زوجته، ويقرأ مقالاته التي نشرها في «ملحق النهار»، قبل أن تلفت نظره خاصةً مقالة شهيرة له عن الفريز. عندما نظرتُ إلى صورة باسل، تساءلتُ بدوري عن فاكهته المفضّلة. كنتُ أعرف أني لن أجد جوابي في أيّ من شهادات أصدقائه المكتوبة. لم أعثر إلا عليه يبتسم لي في الصورة، وطفا نَمَش وجهه على وجنتيْه وأنفه أكثر. النَمَش النَمَش هو أثر الشيء في غيره، والنَمَش خطوط النقوش من الوَشْي ونحوه، والنَمَش [&hellip
..المزيدمقالات نُشِرَت في الصُحُف
نغضب ولا نحزن
نُشر فيFebruary 27, 2016
أعرف الكاتب أحمد ناجي منذ ما يقارب العشرة أعوام. كان ناجي بوابتي الأولى لمعرفة القاهرة وأهلها. نزهتي الأولى في وسط البلد كان معه. لقد مرَّت دورة كاملة منذ تلك الزيارة. عقدٌ كامل بدأ بحركة كفاية، مرورًا بالثورة المصرية وصولًا لمصر المجلس العسكري، ومن ثمَّ مصر الإخوان، وانتهاءً بمصر السيسي. قبل نزولي القاهرة، تحادثنا وتعاركنا وتحادثنا على مدوَّنته ومدوَّنتي وفي الإيميلات. هناك من العراكات بيننا ما يصعب حصرها بيننا كمجموعة كانت تكتب في فضاء الإنترنت العام آنذاك: الإسلام، الحركات المسلَّحة، القضيَّة الفلسطينيَّة، الغرب، إلى آخر المواضيع القليلة التي تحدَّد الحديث فيها قبل العام ٢٠١١. أنا آتي من إرث عروبي وقومي أحاول الخروج منه بتأنٍ وبلا ردَّات فعل متطرّفة، وهو ينطلق من مصر مبارك التي لا أعرف عنها كثيرًا، فأحصرها في عالم [&hellip
..المزيدحراك الخارجين: “ابتعدوا عنه.. دعوه يتنفّس!”
نُشر فيOctober 1, 2015
شهدَت الأيام القليلة الماضية محاولات السلطات اللبنانية طمر الفراغ، بعدما حضر مجددًا في رأس “الدولة” وعليه، مع امتناع إحدى مؤسّساتها الخاصة عن ستر النفايات، بوصفها شكلًا من أشكاله، لتحتلّ القمامة البلد، ويتوزّع المكبوت أمام الأعين، ويبين اللامرئي مرئياً، ويصير نظام التخلّص والطمر معطلاً. انهارَت النظافة، ومعه الجسد الذي تنتجه، وربما لأنها تنتجه، قرف الجسد وانقبض. لكنّ موت الجسد محظور، فالسلطات لا تريد وقايته، لأنها تود الإبقاء على خوفه لتحكمه. والوقت المحكوم بالعوامل الطبيعية يساعد في تمكين مثل هذه السيطرة على أجساد لم تنقبض بعد. الفراغ حيّ في لاوعي السلطات، فهو يظهر مع انكشاف حدود علاقاتها ببعضها، مدفوعًا إلى حده الأقصى بسبب فراغ موقع سلطة ما فوق السلطات وفيها. وتحت محاولات التحكم به، لا تريد السلطات أن تفعل شيئًا، لأنها ببساطة [&hellip
..المزيدهزّوا جذع الشجرة!
نُشر فيSeptember 11, 2015
المدينة صفراء، قلتُ ناظرًا إلى الصوَر. وتذكرتُ ملصقًا مخزقًا لمسرحية بالقرب من مسرح أغلق. كان اسم المسرحية: “بيروت صفرا”. لم أشاهد المسرحيّة. وكنتُ وقتها بعيدًا عن هذا “الجو”. أخذتني سنوات كثيرة حتى أعرف ماذا أفعل. وهذه على الأرجح سمة في مدن تغلق مسارحها وأماكنها العامة واحدًا إثر آخر، وتدفعك للرحيل: أن لا تعرف، وأن ترحل لكي تعرف. كيف يكتب أحدنا عن المكان؟ وكيف نكتب عن أنفسنا؟ وكيف نصير المكان ويصيرنا؟ لا أسئلة جديدة هنا، والكلام عن هذه الأشياء يبدو قد نفد. خلّصه كثيرون ممّن كتبوا وسطّحوا. وفي خضمّ طرح المعاد، يبدو في لحظة أنّ كل شيء مقلوب، وأننا قلبناه فجأة وصرنا نسلك إلى باطنه، وكلّما تقدّمنا تفاجأنا بما لم نتوقعه، أو بما توقعناه ولكنّنا لم نتوقعه على هذا النحو بالفعل. [&hellip
..المزيدالموزعون والقنوات: لا فقر ولا حرية
نُشر فيMay 5, 2015
يفضح الخلاف المستعر بين القنوات التلفزيونية اللبنانية وموزعي الكابل، التهالك العام الذي أصاب الإعلام التلفزيوني المحلي. فبتحييد نقاش الملكية الفكرية الذي تتسلّح به القنوات (وهو نقاش لا يجب أن يكون مقدسًا، وليس مفهومًا إسباغ القدسية عليه في ظل نقاشات عالمية ليست جديدة حوله)، يجد المتابع نفسه إزاء تأميم خجول لتجربة المشاهدة من قبل قنوات التلفزيون الخاصة نفسها، في محاولة منها لاستنساخ ما يمكن تسميته بـ”تلفزيون الشعب”. فالمشاهد اللبناني سيدفع للقنوات الخاصة (وتلفزيونه الرسمي؟) التي لا تفصح له عن أرباحها ولن يحصّل منها شيئًا. إنه مدفوع لتلبية نداء الواجب الإعلامي/الوطني ليحول دون انهيار مشروع الاعلام التلفزيوني اللبناني، بلا حقوق تذكَر. منحى الخلاف هذا، يعيد إلى الأذهان نشأة المحطات التلفزيونية الخاصة نفسها التي تُشابه نشأة شركات موزعي الكابل. والفرق بين النشأتين، أن القنوات [&hellip
..المزيدإليسا تغنّي “موطني”: اتفاق تفاهم
نُشر فيMay 1, 2015
كان يمكن لغناء إليسا نشيد “موطني” (إبراهيم طوقان – محمد فليفل) أن يمرّ مرور الكرام لولا أن الفنانة أعلنَت أكثر من مرة قربها السياسي من حزب “القوات اللبنانية” وزيارتها لرئيسه. هنا مكمن الجدل. لا في نطق المغنيّة المخفّف لحرف الطاء، أو أخطائها في الكلمات وتشكيلها، أو المستوى الفني للنسخة التجارية من النشيد (والذي يزكّي لحنه، أصلاً، المزاج التعبوي المرتبط غالباً بهذا النوع من الأناشيد). بأي حال، ليست هذه النسخة المخفّفة الوحيدة من النشيد. في “يوتيوب” وحده أكثر من نسخة، واستخداماته تتعدّد بين الأناشيد الحزبيّة وإعلانات كرة القدم والمغنين الشباب وكورالات المدارس. لكنّ ردّ الفعل على غناء إليسا انطلق من مغالطة أساسية، وهي التعامل مع نشيد فلسطيني سابق، وليس مع ما أصبح النشيد الوطني لدولة العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي. ليس هذا ذمّاً [&hellip
..المزيد“فرش وغطا”: الصمت والصخب
نُشر فيOctober 29, 2013
ملاحظة: هذه القراءة قد تحتوي، في بعض تفاصيلها، على مفسِدات فرجة معاكسًا لمناخ البهجة الوطنية المصرية الحالي، يأتي فيلم “فرش وغطا”، التجربة الروائية الثالثة للمخرج المصري أحمد عبد الله السيد، بعد “هليوبوليس” (٢٠٠٩)، و“ميكروفون” (٢٠١١). ففيما عرض “هليوبوليس” المزاج الاكتئابي المرافق لترهل دولة يوليو في أطوارها الثلاث التي أفضت (من ضمن ما أفضت) لوحدة وهرب الأقليات وتشوّه العمارة وتعاظم حلم الهجرة، جاء “ميكروفون” الذي، للصدفة، طُرِح حينها في الصالات المصرية عشية الثورة، أكثر تفاؤلًا، مقدمًا بيئة شبابية موسيقية متمردة على مؤسسات الثقافة المصرية، ومبشرًا بمزاج اعتراضي شبابي تصدّر الصورة العامة للثورة المصرية. وإذ تشارك الفيلمان الأولان لعبد الله في رواية قصص “الحب الفاشل” بالتوازي مع باقي التفاصيل في ثنايا الحبكة الفيلمية، فإنهما انتهيا أيضًا إلى النهاية الخافتة السلبية نفسها، الأول [&hellip
..المزيد“رقّصوك” لـ “مشروع ليلى”: البحر مبتلعاً النهايات
نُشر فيSeptember 4, 2013
أخيرًا، طرح الفريق الموسيقي اللبناني “مشروع ليلى” أسطوانته الثالثة “رقصوك”، بفارق عامين عن أسطوانته الثانية “الحل رومانسي”. جاء ذلك بعد فترة من التأخير لم تعرف مسبّباته، قبل أن يقوم الفريق بدعوة مستمعيه إلى دعمه ماديًا على موقع Zoomal لإصدار الأسطوانة وتمويل الحملات الإعلاميّة اللاحقة وأشرطة الفيديو المصاحبة لهذا المشروع. لبّى متابعو الفريق النّداء، فموّلوا مشروع فرقتهم، ليصبح بذلك، من أوائل المشاريع العربيّة التي تموّل جماعيّاً، وعلى هذا النحو. لم يكن توقيت طرح الأسطوانة أكثر مؤاتية من الوقت الحالي. فوسط أحداث مشحونة من مصر لسورية للبنان، طرحت الأغنية العاشرة في الأسطوانة “ونعيد ونعيد ونعيد” التي بدت كاستعادة جديدة للعنة سيزيف الأبدية، وجاءت متّسقةً مع هذه الظروف المحيطة. إنها الأغنية التي تحكي عن جماعة غير واضحة المعالم، ملعونة بلعنة المجابهة المستمرّة في محيط محكوم بجنون لا يكاد [&hellip
..المزيد“ونعيد..”: الاستعادة الجديدة للعنة سيزيف
نُشر فيAugust 17, 2013
بقي من قصّة سيزيف، الذي خدع إله الموت، لعنة كبير الآلهة الشهيرة: أن يبقى يحمل الصخرة حتى أعلى الجبل قبل أن تتدحرج منه، ليعود يحملها ويصعد الجبل لتتدحرج منه ثانيةً ويلحقها من جديد. تستعاد هذه اللعنة مع أغنية “مشروع ليلى” الجديدة: “ونعيد ونعيد ونعيد” التي أطلقها الفريق بعد نجاحهم في تجميع المال من مستمعيهم على الويب لإنتاج وتوزيع أسطوانتهم الجديدة “رقّصوك” (تجربتهم هذه، ومضمون حملتهم الإعلامية #OccupyArabPop يحتاجان مقالة منفردة). وُضِعَت الأغنية على صفحة الفريق على الفيسبوك بعد دقائق من انفجار الرويس في بيروت، وبعد أيام قليلة على المقتلة الدائرة في مصر، لتبدو أشبه بالأغنية الخلفية للجنون الدائر، المعروف مرتكبيه في حالة حالة مصر، والمجهّل مرتكبه حتى الآن في حالة لبنان. تركّز الأغنية على التكرار الثابت، مستعيدة عذاب سيزيف الأبدي. لكنّها لا تقف عند [&hellip
..المزيد“موجة حارة”: عودة عكاشة
نُشر فيAugust 7, 2013
عاد أسامة أنور عكاشة بعد رحيله. لكن عودته كانت مختلفة عن كل ما حققه من مسلسلات. على الأقل، في الموضوع. فمسلسل “موجة حارة”* الذي حققت معالجته الدرامية السيناريست مريم نعوم بمشاركة أربعة كتّاب حوار شباب، والمستند إلى رواية كتبها عكاشة في أوائل الألفية (منخفض الهند الموسمي) يعالج موضوعًا “غير عائلي”، الأمر الذي كان يحرص عكاشة على الابتعاد عنه في أعماله التلفزيونية، بعكس أعماله السينمائية. ففي أعماله التلفزيونية لن نرى مشاهد متطرفة لخيانة وتعاطي مخدرات، كما في فيلمه “الهجامة” مثلًا، المنفّذ عام 1992. وفيما عدا جلسات الحشيش التي كان يشوبها الطابع “الكوميدي” في مسلسلاته، ما من تفاصيل تخطت هذه الحدود الرقابية. ليس معروفًا إن كان هذا الابتعاد قرارًا ذاتيًا من عكاشة أو تقيدًا بمنظومة رقابية رسمية آنذاك، لكننا نعلم أن اسمه [&hellip
..المزيد